حوار ، ومحاور كن أول من يقيّم
حوار مع د. رجاء عودة 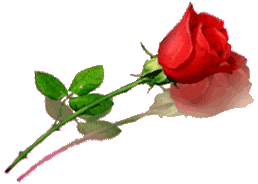 شمس الدين درمش شمس الدين درمش الدكتورة "رجاء محمد عودة" مثال رائع للمرأة المسلمة الواعية، المجاهدة، التي تحرص على الإسهام في نهوض مجتمعها، ورفعة بنات جنسها. تزوَّجت الدكتورة رجاء قبل حصولها على الشهادة المتوسطة، ورُزقت خمسة أولاد، ورغم ثقل مسؤولية الحياة العائلية، ومتطلباتها، وتربية الأولاد، إلاَّ أنَّها لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مواصلة الدراسة التي أقبلت عليها تنهل من العلم وتتزوَّد بالمعرفة. وحينما طرحت الرئاسة العامة لتعليم البنات نظاماً جديداً لاختبار الشهادة المتوسطة، وهو نظام (السنة الواحدة) حيث يُتاح للطالبة امتحان الثلاث سنوات بامتحان واحد، كانت من أُولى المتقدِّمات للاختبار. وممَّا بعث الطمأنينة في نفسها واستئناسها بالدراسة، وجود ابنتها الكبرى "جمانة" معها في المرحلة نفسها ضمن النظام العادي، فكانت رفيقة دربها العلمي لعدَّة سنوات، حيث حصلتا على الشهادة المتوسطة معاً، ثمّ الثانوية، إلى أن حصلتا على درجة الدكتوراه، مع اختلاف التخصص، فحصلت جمانة على الدكتوراه في أمراض النساء والولادة، وحصلت الدكتورة عودة على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. موقعنا "لها أون لاين" التقى الدكتورة رجاء محمد عودة، فكان هذا الحوار الثري: * لم يكن الزواج عقبة في سبيل التحصيل العلمي، إذا توفَّرت العزيمة الصادقة، ومساعدة الزوج وتشجيعه، ثمَّ تنظيم الوقت واستغلاله في حقل الدراسة، ومن واقع تجربتي الذاتية لم يكن الزواج عائقاً لي؛ لأنَّ الدراسة كانت أمنية غالية في حياتي، فحرصت على اغتنامها عندما سنحت لي الفرصة، وكان زوجي ـ جزاه الله خير الجزاء ـ خير مشجِّع لي ومسانداً على تجاوز العقبات التي صادفتني. وكنتُ أستغل كلّ دقيقة من وقتي للدراسة والتحصيل، حتى عندما أقوم بأعمالي المنزلية كانت كراسة المحاضرات والكتاب الجامعي يرافقاني إلى المطبخ، حيث لم يكن لديَّ وقت كاف للدراسة دون إنجاز الأعمال المنزلية، ولم تكن لدي حينئذٍ مُساعِدة في المنزل تتحمَّل عبئاً من هذه الالتزامات، هذا فضلاً عن العناية بأولادي الستّة تربوياً ودراسياً، وكانوا (بحمد الله) متفوقين دراسياً. وإلى جانب ذلك كنت بعيدة عمَّا يشغلني عن جوّ الدراسة، فمثلاً كنت لا أزور ولا أُزار إلاَّ للضرورة القصوى، حيث كنت أعتبر ذهابي للجامعة منطلقاً ترويحياً يغنيني عن النزهات الأخرى، وكنتُ أستمتع حقَّاً في أجواء الجامعة، وأشارك في معظم الأنشطة الثقافية، ونلت بعض جوائزها في مسابقة القرآن الكريم، والقصّة القصيرة. وكان حبُّ المنافسة العلمية ميداناً ممتعاً لإثبات الذات، واستثمار الوقت، وعدم الإحساس بالفارق العمري مع الزميلات. * كان اختياري لموضوع الماجستير ثمرة بحث دائب حول نوع من الشعر يتجاوز المواقف الرسمية، وشعر المناسبات، إلى شعر يتغلغل في أعماق الحياة، ويؤدِّي وظيفته فيها، بعد أن كانت غالبية الدراسات تتناول موضوعات تقليدية عامة، كالمديح، والهجاء، والرثاء، والغزل، وغير ذلك، أو بعض القضايا التي لا تمتُّ بكبير صلة إلى داخليات الشاعر الخاصة، التي تتطلَّب معاناة من نوع خاص، تقتضي التعبير عنها بصورة ملحّة. ومن هنا وضعتُ يدي على نوعٍ من الشعر له صلة بالحياة، ويتفاعل معها، وهو: "شعر الأسرة في العصر الأموي". وقد اخترت العصر الأموي لسببين رئيسيين، الأول: أنَّ هذا العصر قريب العهد من عصر التدوين، فهو يقوم على دعائم أكثر اطمئناناً من سابقه، والسبب الآخر: هو الكشف عن وجه آخر للعصر الأموي في شعر وجداني مداره الصدق، لم تطمس معالمه الأحداث التاريخية، والصراعات السياسية. وقد أفضت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة، كان منها: أنَّ العصر الأموي ساده الوئام الأسري، بخلاف ما عُرف عنه من الصراعات السياسية، والثورات المتعددة. وهذا يعكس مدى دور الأسرة في ضبط موازين الحياة والمجتمع. كما يدلّ على أنّ شعر الأسرة كان متطلباً وجدانياً من متطلبات الحياة، حيث وجد فيه الشعراء السكن النفسي، والدفء العاطفي الذي يتفيؤون ظلاله كلّما أعيتهم متاعب الحياة وهمومها. وقد سعدتُ جداً بهذه الدراسة؛ حيث قادتني ـ عن طريق الصدفة ـ إلى اكتشاف معلم أدبي جديد، وهو "غزل الحليلة"، وهو غزل لم يُسلِّط أحد الضوء عليه، وهو غزل واضح المعالم، يُعدُّ بحق: البُعد الثالث للغزل في الأدب العربي، إزاء اللونين الآخرين: العذري والصريح، لا سيما وهو معاصر لهما زمانياً ومكانياً، وقد أطلقتُ عليه "غزل الحليلة" مقابل "غزل الخليلة" الذي يمثّله الغزلان الآخران، سواء كان عذرياً أم صريحاً، فهما غير جائزين شرعاً، ولهذا يندرج هذا الغزل بقوّة في ثنايا الأدب الإسلامي شكلاً ومضموناً. وهو قد شكَّل متطلباً حيوياً، ومنطلقاً مشروعاً للتعبير عن مشاعر الحب والود؛ ولا غرابة أن تحتل الزوجة هذه المكان من قلب زوجها وعطفه، فهي النصف الجميل المكمل للرجل، فبها تكتمل سعادته، ومعها ينشأ مجتمعه الصغير، وبمساندتها يتغلَّب على صعاب الحياة، وإليها يُفضي عندما تثقل كاهله هموم الحياة، وهي عونه في السرَّاء والضرَّاء، وهي فوق هذا وذاك سكن نفسه، يتفيأ معها ظلال المودَّة والرَّحمة، قال تعالي: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودَّة ورحمة...}. غزل الحليلة * قد يستغرب بعضهم تغزُّل الزوج بزوجته، إذ من المعروف أنَّ الغزل يحتاج إلى معاناة وجدانية تلهب خيال الشاعر وأحاسيسه؟ * هؤلاء أردّ عليهم من واقع النصوص التي تقول إنَّ أوضح ظاهرة في شعر الأسرة، سواء على صعيد النصوص الشعرية أم على صعيد الشعراء، كانت ظاهرة "غزل الحليلة"، إذ بلغ عدد الشعراء القائلين فيها ثلاثة عشر شاعراً كان منهم ستّة من المشهورين.. حتى إنَّ أحدهم وهو "هدبة بن الخشرم العذري" قد صدّر أكثر شعره رسائل ودِّية مع زوجته، حيث قضى في السجن عدة سنين، كانت مصدر بثّه وسلواه. هذا إضافة إلى أنَّ كثيرين منهم كان يستشعر الحنين والشوق لزوجته وصغاره، وهو بعيد عنهم، إمَّا في ميادين الجهاد، أو لطلب الرزق، أو السعي لنيل العلم، وسوى ذلك. وممَّا لفت نظري أنَّ هذا الشعر تميَّز بخصائص فنية عن الغزلين الآخرين، فمثلاً كان شاعر غزل الحليلة يعتدُّ بنسب زوجته وأصالتها، وحبِّها له، وحنانها عليه، بحيث لا يطول غيابها عنه، في حين كانت توصف الأخرى بهجرانها وإخلافها وعدها، فضلاً عن أنَّه لا يعتدُّ بنفسها وكرم منبتها!! * من النتائج التي أبرزتها الدراسة: شخصية المرأة في العصر الأموي، وهي: شخصية المرأة الفصيحة البليغة، ذات الشخصية القوية التي حدَّدت مسار حياتها وفق إرادتها، وتحقيق إنسانيتها، ممَّا جعلها معلماً بارزاً لمرحلة حضارية متطوِّرة، سبق فيها كلّ المؤتمرات الدولية للمرأة بعدَّة قرون. ولعلِّي قد أطلتُ في الحديث عن مضمون رسالة الماجستير، لكنِّي أجد أنَّ بيان هذه السمات ضرورية لإبراز مكانة تراثنا الأدبي الإسلامي ومعالمه الحضارية في عصر العولمة!! ملامح من أدب البنوة * رسالة الدكتوراه التي وسمت بعنوان "أدب البنوّة في نثر العصرين الأموي والعبّاسي الأول" معلم آخر من معالم تراثنا الحضاري الإسلامي، ولن أطيل في بيان ما أفضتْ إليه من نتائج، لكنِّي سأشير إلى ملمحين بارزين؛ الأول: أنَّ هذا الأدب الذي مرَّت عليه مئات السنين من (41ـ232هـ) ما زال أخضر ندياً يعايش حياتنا، ويخالج وجداننا، ويمسّ قضايانا، ففي الوقت الذي عنى فيه بعلاقات الآباء بأبنائهم، وحكى حكمتهم وتجاربهم من خلال: الوصايا، والرسائل، والخطب، والأمثال، والحوارات، عُني أيضاً بتكوين الناشئة الذين هم حجر الزاوية في بناء الحضارة، وأجال نظره في ميادين نشاطهم كافّة ، فعبَّر بذلك عن مرحلة ناضجة للفكر الإنساني في تشكيل الشخصية السويّة المتوازنة. وإذا كانت قيمة التراث تُقاس بمدى ما يستطيع رفد الحياة المعاصرة بمقوِّمات بناء حاضرها ومستقبلها، فأحسب أنَّ هذا الأدب قادر على الإسهام في ذلك؛ لأنَّ له سابقة ومثالاً، فقد عُني بتكوين أولئك الروّاد الأوائل للحضارة الإسلامية، أمثال:عبدالملك بن مروان، وابنه الوليد، وعمر بن عبدالعزيز، وهارون الرشيد، وابنه المأمون، وسواهم؛ لأنَّ هذا الأدب دار حول هذه الشخصيات وصدر عنها، فكان كثير من الخلفاء والولاة والقوّاد مستقبلاً ومرسلاً للرسالة النبوية. إلى جانب أنَّ هذا الأدب قد شكَّل ركيزة من ركائز التراث الأدبي؛ لاحتوائه على غالبية الألوان النثرية التي شكَّلت النثر العربي في حقبة نضج النثر العربي وازدهاره. أمَّا الملمح الثاني لأهمية أدب البنوة، فهو: القيمة المرجعية للنصوص البنوية على صعيد الدراسات الإنسانية الأخرى: التاريخية والاجتماعية والتربوية، فعلى صعيد الدراسات التاريخية تُعدُّ النصوص البنوية وثائق تاريخية سياسية مهمّة، شكّلت أحداث العصر، وأنظمة الحكم فيه، وقدَّمت الأطروحة المنهجية للسلطة النموذجية لقيادة الأمّة، على مستوى صلاح الراعي والرعيَّة. وعلى صعيد الدراسات الاجتماعية عُنيتْ النصوص بالتنشئة الفردية والاجتماعية، كما طرحت قانون التكافل الاجتماعي، يعزّزه قانون العقوبات لصيانة هذا القانون من التهاون والإهمال، فضلاً عن كشفها عن التغيّر الاجتماعي الذي واكب مسيرة المجتمع العربي من العصر الأموي إلى العباسي. وعلى نطاق الدراسات التربوية، استطاعت النصوص البنوية التأصيل لمنهج تربوي متكامل على مستوى النظرية والتطبيق؛ إذ حققت المفهوم الشامل للتربية باعتبارها عملية تنمية للشخصية المتكاملة المتوازنة. وهذا المنهج التربوي سوف يحقق تطلعات خبراء التربية الإسلامية وآمالهم في إيجاد مناهج تربوية إسلامية، دون اللجوء إلى النظريات الغربية التي تتنافى مع قيمنا الإسلامية، وهو على هذا يُعدُّ موضوعاً خصباً لدراسة تربوية مقارنة. * نعم، هناك ارتباط وثيق بين موضوعي شعر الأسرة وأدب البنوة، والحياة، فالأسرة نواة المجتمع، والبنوة أساس الأسرة، وهي علاقة وطيدة مثّلت العلاقة بين الخاص والعام، وقد اتضح هذا التواصل جليّاً من خلال حديثي عن موضوع الرسالتين. هوية المسلم * هل تقول د.رجاء إنَّ الأدب الإسلامي له وجوده القوي في أغراض أخرى غير أدب الدعوة الإسلامية المباشر؟ ومن ثم: هل يمكن أن نقول: إنَّ الدعوة إلى الأدب الإسلامي اليوم ليست دعوة إلى شيء جديد، بل هي إبراز لما هو موجود؟ أولاً: إنَّ الأدب الإسلامي هو أدب الحياة؛ لأنَّ الأدب لا ينفصل عن الحياة، بل هو مرآتها، وصورتها التقويمية بصورة فنية موحية. وليس هناك أفضل من معيار تقويمي للحياة سوى الإسلام؛ لأنَّه منهج الله الذي {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}، وهو منهج الخالق لخلقه الذي هو وحده ـ سبحانه ـ يعلم ما ينفعهم وما يصلحهم، وهل هناك أحد يستطيع أن يضع منهجاً لصنعة أفضل من صانعها؟ فالأدب الإسلامي هو هويّة الأديب المسلم، وعندما ينطلق هذا الأديب في تعبيره ـ أيّاً كان موضوعه ـ من رؤية إسلامية، وبصورة تعبيرية موحية، يُعدُّ هذا الأدب أدباً إسلامياً بكلّ أبعاده الجمالية، حتى وإن لم يستخدم فيه أيّة عبارات أو مفردات إسلامية، طالما أنَّه لم يخالف التصوُّر الإسلامي فيما يعبِّر عنه، وهذا يوضِّح لنا أنَّ الأدب الإسلامي لا ينحصر في إطار الدعوة الإسلامية، شعراً كان أم نثراً. ثانياً: إنَّ الدعوة للأدب الإسلامي ليست بدعاً من القول، أو بعبارة أخرى: ليست دعوة إلى شيء جديد، بل هي إبراز ومعايشة وتفاعل لما نؤمن به من عقيدة، وسلوك، ونظام حياة. فكما قلت إنَّ الأدب الإسلامي هو هوية المسلم، أيَّاً كان موقعه، ودرجة استقامته، فيكون معبِّراً عن ذاته وانتمائه ورؤيته ونظرته للحياة، وإن لم يكن الأدب كذلك فيكون شيئاً مستغرباً، حيث يفقد الأدب هويّته، وأصالة منشئه، وصدق انتمائه لعقيدته. ـ يُعدُّ هذا المؤتمر معلماً بارزاً من معالم الأدب الإسلامي، ورسوخ قدمه على الساحة الإسلامية والعالمية، فهذا المؤتمر الدولي (الذي عُقد لأوَّل مرَّة على مستوى العالم الإسلامي) قد حقّق ثماره الطيبة بتفعيل دور المرأة المسلمة على مستوى التنظير والتطبيق. ومن الناحية الأدبية فقد حقّق هذا المؤتمر لأوَّل مرّة الفرصة لتقويم أدب المرأة المسلمة سلباً أو إيجاباً، أو بعبارة أخرى: تقويم هذا الأدب: ما له وما عليه. وقد تمَّ ذلك من خلال ثلاثة محاور: المحور الأوّل: بيان أنَّ الحركة الأدبية النسائية ـ بوجه عام ـ لم تنهض على أسس إسلامية، فبدأت هذه الحركة تتجاذبها التيّارات الفكرية الغربية بشتّى توجهاتها تلك، التي كان منها الدعوة لتحرير المرأة، ومساواتها بالرجل، ونبذ الحجاب، والدعوة للاختلاط، وما إلى ذلك. فكان هذا المؤتمر وسيلة لتسليط الضوء على هذه التوجهات الأدبية وتيّاراتها الفكرية، وما آل إليه حال المرأة نتيجة لذلك..! والمحور الثاني: تمثَّل في تقديم نماذج أدبية لبعض الأديبات الإسلاميات اللواتي كان أدبهن منبثقاً عن المنطلق الإسلامي، فكان لأدبهن تأثير بالغ على تنشئة الأجيال. أمَّا المحور الثالث: فطرح من خلاله تحديد الأدوار الأدبية الإسلامية، وتذليل ما قد يعترض طريقها من صعوبات. وقد طرح في هذا المؤتمر أكثر من ثلاثين بحثاً ـ إلى جانب تقويم أدب المرأة: ما له وما عليه ـ موضوع "الأديبة الإسلامية وأدب الطفل"، طُرحتْ من خلاله عدّة بحوث تبرز ضرورة اقتحام ميدان الكتابة للأطفال بصياغات جديدة تخاطب الأطفال برؤية معاصرة مواكبة لمتغيرات الحياة، بحيث تكون مبشِّرة بالإسلام، ومحافظة على ثوابته وقيمه. وقد سعدتُ بالمشاركة في هذا الملتقى ببحث عنوانه: "الأديبة الإسلامية وقضايا الأمَّة، سهيلة زين العابدين ـ نموذجاً ـ وقد حقَّق هذا الملتقى (بفضل الله، ثمَّ بجهود القائمين عليه) أهدافه التي فاقتْ كلّ التوقعات، وأخصُّ بالذكر جهود الأستاذ الدكتور "عبدالقدوس أبوصالح" الذي بذل جهداً جبَّاراً لعقده، وترتيبات نجاحه، وكذلك الأخت سهيلة زين العابدين حمّاد، رئيس لجنة الإديبات الإسلاميات، ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى. |